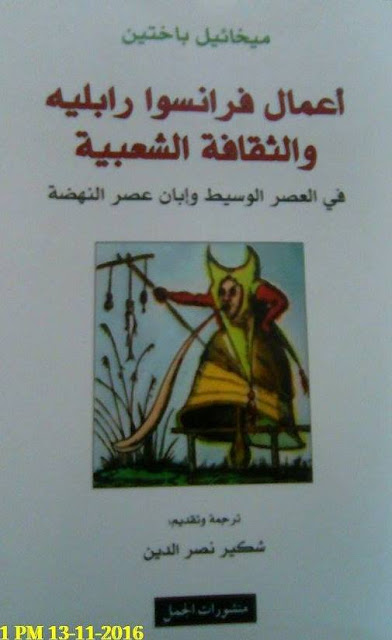كانت
الغواية في مبتداها فعلا شيطانيا، تلقفته المرأة وبثته للعالم، وكان الرجل، الذي ظل
منذ خطيئة آدم الأولى، رهين الغواية الأبدية وأسير الصبابات البعيدة، ومدار الفتنة
وضحية الافتتان من امرأة نجحت دوما في الإتيان بالشيطان، الغاوي الأول، مكبلا في قارورة،
ليس بنية تخليص العالم من شروره، إنما لتحل محله وتنوب عنه وتستحوذ على وظيفته الأثيرة:
الإغواء، وهي تعلن كل مرة، من موقع الضعيف الذي يستقوي بالفتنة والغواية، عن الاستحواذ بـ/وعبر جلال الأنوثة، على الغواية كفعل تمارسه المرأة نيابة
عن، وتجاوزا للشيطان، الذي ظل، في مواضع كثيرا، يتراجع كسيرا حسيرا، ومفتونا، بقدرة
المرأة الفاتنة، الغاوية، ذات السلطة والسلطان على أن تحل محله وتنوب عنه في شد الحبائل
والنفخ في البوق.
المرأة الغاوية
تتمظهر المرأة في المخيال الجمعي لمجتمعاتنا المسلمة كسبب
مباشر للفتنة، لهذا يكثر التحذير الديني من فتنة النساء وغوايتهن، وهو ما يتم التعبير
عنه بالكيد: { إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}، وهذا الكيد العظيم المحذر منه قرآنيا،
والمدعم بأحاديث توكيدية وترسانة كبيرة من الفتاوي والنصوص التأويلية التي تدين المرأة
وترميها بتهمة الكيد، وهي التهمة التي تموضع الرجل، الذي كان هو المنتج للخطابات المُدينة
للمرأة، في موضع الضحية؛ إنه المفتون في دينه بسبب جمال المرأة وجبروت فتنتها. فالكيد
هنا مرتبط " بالزيغ الجنسي" في المخيال الديني الإسلامي، والذي لا يزال قوي
التأثير والتحكم في سلوكياتنا، ومساهما فعالا في بناء مواقفنا من القضايا التي تجابهنا
في الواقع المعاش. إن تحذير الفقهاء من فتنة النساء، وتوكيدهم على أن المرأة غاوية
بالضرورة، ولهذا يجب سترها خلف الحجاب وتضييق المراقبة عليها، وحماية عفتها منها، بما
أن العفة مطلب رجالي قبل أن تكون قناعات نسائية. الفتنة في معناها اللغوي تعني الإكراه على الشيء، ولكن توظيفها حين يتعلق
الأمر بالمرأة يصير ذو معنى مفارق، يصير المعنى يحيل على الجر إلى المعصية، جر
يقوم على الجذب ويتوسل بالغواية لأنه يفتقد لقوة الإكراه، والمرأة الغاوية التي هي
موضوع الفتنة وسببها، يبقى جسدها، المطلوب حجبه وتغطيته، هو الوسيلة والأداة لأحداث
تلك الفتنة التي تشكل تهديدا لإيمان الرجال وصلاحهم من خلال دفعهم عبر ما تثيره فيهم
من فتنة إلى ترك النواهي الدينية جانبا والانسياق وراء الحرام الذي هو الزنى وأيضا،
بحسب الرؤية الدينية، الانشغال بالنساء ولواعج الغرام عن أمور الدين.
إن مكر
النساء، ورغم قوة توظيفه في الخطابات الدينية، يظل في حقيقته تهمة أكثر من كونه تعبيرا عن حقيقة ماثلة، وربطه
بالفتنة وربط الفتنة بالمرأة تحديدا يبدو ربطا تعسفيا؛ فالمكر بمعناه العام أمر مشترك
بين النساء والرجال، وإذا كان مكر النساء قد وصف قرآنيا بالعظيم إكبارا له وتهيبا من
فداحة نتائجه، إلا أن القرآن نفسه لا يربطه بالمرأة ولا بالغواية الجنسية. يعطينا القرآن
النموذج الأبرز لمكر النساء ممثلا في حادثة النبي يوسف عليه السلام مع زوجة عزيز مصر،
وهو مثل مراوغ حيث المكر النسائي الذي يرتبط في مخيالنا بالفتنة كأداة لذلك المكر،
تنقلب في القصة القرآنية لتصير مكرا نسائيا لم يحدث إلا كرد فعل على فتنة رجالية هي
فتنة سيدنا يوسف لامرأة العزيز ومن بعدها لنساء مصر، فالقرآن لا يربط الغواية بالمرأة،
كما أنه كنص مؤسس لثقافة الشعوب الإسلامية، لا يدين المرأة/ حواء بفعل الغواية الأولى
التي أخرجت آدم من الجنة، بمقدار ما يؤكد على معصية آدم { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}.
الحب باعتباره فعل تمرد
غواية
الحب تكمن في قدرة المتحابين على الانفلات من سلطة المجتمع وقدرته على مأسسة الرغبة،
وشرعنة المتعة، والدفع باللذة عبر قناة وحيدة هي الزواج. المجتمع الذي يتخذ من الدين
شرعية الإخضاع يحث على الحب الخاضع للعرف، المقولب، المنزوع التمرد، والمنصاع لما يطلب
من المتحابين تأديته كضريبة للمتعة، فلا متعة في مناطق الظل ولا رغبة تنبجس دون مباركة
"الحلال" وطقوسه التي تعلن أحقية رجل وامرأة في ممارسة جنسية غير مدانة،
إننا أمام الحب الرسمي، الذي تنتفي فيه الغواية كمحفز، وكوسيط يؤجج لهيب الشوق بين
طرفي الرغبة الساعي كل واحد منها إلى حضن الآخر وقلبه آهل بالصبابة والمسرات الموعودة
التي تنخصي غالبا تحت وطأة المؤسسة، حين تتحول العلاقة، التي أساسها الانفلات ورفض
النمذجة، إلى عرف وسلوك متعارف، وواجبات تؤدى قهرا حتى دون الشعور بالمسؤولية التي
تجعل للواجب قبولا من النفس يستحيل إقبالا على الالتزام به دون الشعور بوطأة الجبر
والقهر الاجتماعي، هكذا "حب" يعيش تحت هاجرة العرف يستحيل بمجرد انتماء طرفيه
إلى المؤسسة، إلى مجرد علاقة اجتماعية، مما يجعل سؤال الحب والرغبة والغواية في تلك
العلاقة مطروحا بإلحاح دون إجابات حاسمة بسبب تعقد تلك العلاقات الممأسسة التي تسمى
زواجا وما يتفرع عنها من علاقات ذات طابع أسري ينمي الاجتماعي على حساب العاطفي، والجماعي
على حساب الحميمي، والمتعة على حساب الرغبة، وفي كل ذلك تذبل وردة الشغف في القلوب
التي كانت عاشقة، لتنمو ورود أخرى للشغف والصبابة على هامش المؤسسة في ظل العلاقات
الموازية؛ تلك العلاقات المدانة باسم النزوى والخيانة والتي تتحول فيها الحبيبة، في
نظر المجتمع، والمؤسسة، إلى مجرد عشيقة منذورة للنكران متى اكتشف أمرها، ومنظورا إليها
كعاهرة، و"خطافة رجال". مع الحبيبة التي يلوذ بها الرجل ويأوي إليها، ومع
الحبيب الذي تلوذ به المرأة بعيدا عن المراسيم والطقوس، وتحايلا عن قوة المنع الاجتماعي،
ينمو الحب الأصدق، الأعمق، والأكثر حميمية؛ ذلك الذي لا يحتاج لإذن كي يتحقق لأنه يستمد
إذنه وشرعيته من ذاته لهذا يعيش المتحابون، بعيدا عن مؤسسة الزواج، وضد بعض الوضعيات
العائلية التي ترضى بالقرب دون أن تتسامح مع انمحاء الحدود، العمق والهيام والرغبة
التي تستولد نفسها من ذاتها، وتتجدد عبر إنفاقها
مقابل تحصيل المتعة؛ تلك الولاّدة للذة، راعية الصبابة التي تعصم الشغف من الفتور.
الحب المنفلت من تأطيرات المجتمع للعلاقة
بين الجنسين، رغم قوة الإدانة التي يجابه بها، ورغم كونه، حتى بعد رجات الحداثة العنيفة
التي أصابت المجتمعات التقليدية، لا يزال يصنف ضمن علاقات الهامش، ضمن المهمش والمقموع،
ضمن مجال التمرد ورفض الانضباط، لا يزال، وسيظل يشكل بالنسبة للكثير من الأفراد الباحثين
عن الفرادة والمعنى لحياتهم، مطلب الروح وغاية النفس الشغوفة بالعميق الذي يملؤها؛
لأنه وحده يعطي المعنى الحقيقي للعواطف التي نقرأ عنها دون أن نختبرها بصدق وعمق: الشوق،
الرغبة، اللذة، الحزن، الخوف من الفقد، الشجن، ألم الذكرى، متعة الوصال، لذة القبول،
قلق الانتظار، إنفطار القلب، الثقة وفقدانها، كرامة العاشق، الصبر والمسامحة .... كلها
مشاعر تعاش مع وبالحب المتحرر من قيود المجتمع، ذلك الذي تقذف به المجتمعات التقليدية
نحو الهامش، وأحيانا كثيرة نحو الزوايا المعتمة، لأن العلاقات الممأسسة تخضع لإواليات
أخرى تُقرر بعيدا عن، وبالتعالي على الأشخاص الفاعلين في العلاقة، لهذا يبقى الحب كعلاقة
تندد بالقولبة، علاقة تمجد الذاتية المقموعة لصالح تماثل مطلوب اجتماعيا وممجد قيميا،
وتلوذ بقيم حداثية من قبيل: الفردانية، الحرية الشخصية، الاستقلالية، علمانية الحياة
الاجتماعية، وهي كلها قيم ضد الجمعنة، وضد رديفها: الضبط الاجتماعي الذي يتعين بدور
المؤسسات الناظمة للمجتمع والحارسة لقيمه، خاصة العائلة باعتبارها القامع الأول للحب
كعلاقة حرة بين رجل وامرأة قررا اللقاء بعيدا عن سلطة ورقابة العائلة، وتجاوز النواهي
الأخلاقية التي تبثها العائلة والمدرسة والخطاب الديني، وترعاها، في الكثير من الأحيان،
القوانين القامعة للحرية الفردية؛ القوانين التي تحرس شرطة الآداب في بعض الدول على
تطبيقها دون تمييز بين العلاقات العاطفية وعلاقات
التداول السلعي للجنس، فالحب الذي لا يقدم نفسه كإلزام اجتماعي كما هو حاصل في العلاقات
الزواجية، هو الحب الذي يمنح المعنى العاطفي، رغم هامش المخاطرة الكبير، والكثافة التي
تملأ النفس والتي تتعين بردات الفعل الحماسية
والمستنفرة إزاء مختلف العواطف والمواقف؛ يعيش المتحابون في حالة تهيج عاطفي مستمر،
حيث يكون المحبوب في حياة المحب بمثابة الآخر الذي هو إلى الأنا أقرب؛ والذي تتجه إليه
صبوات وشغف وأفكار وعواطف المحب، في المقابل تنحصر علاقة الزوجين في برمجة الحياة اليومية
على أساس ما تتطلبه الحياة الزوجية من واجبات والتزامات لا تتجه للأسرة ومتطلباتها
النفسية والمادية والجنسية فقط، إنما تتسع نحو الأهل والعائلة أي نحو المجال الواسع
وغير المحدد الذي يحتم على الفرد، المنخرط في المؤسسة، أن يهيء نفسه للتصرف وفق مجموعة
من التوقعات غير المحددة مسبقا، رغم وضوح معالمها بشكل نسبي، التي تبنيها العائلة،
وجماعة الانتماء الأسرية اتجاه الفرد الذي ينخرط، نتيجة كونه، زوجا أو زوجة، في مجموعة
علاقات جديدة، ووضعيات ذات طابع قهري لا تترك هامشا واسعا لحرية الاختيار والفعل، لأن
الفعل والامتناع عنه أيضا، حين يتعلق الأمر بواجبات أسرية، يكون موضوع ترحيب أو إدانة
بحسب استجابة الفرد للتوقعات التي بنتها العائلة وجماعات الانتماء نحوه، فالرجل/ الزوج
منتظر منه أن يفعل ولا يفعل، والمرأة/الزوجة بدورها محاصرة بالتوقعات، والأسوأ أنها
محاصرة بالنواهي لمجرد كونها زوجة، فحرية الفتاة تحاصر بمجرد انتقالها لوضع الزوجة،
ويتم سحب جزء كبير من حريتها بحجج أخلاقية، وغالبا ذات طابع جنسي، فالمرأة/ الزوجة
تكون متاحة جنسيا وعاطفيا لرجل واحد، حسب التصور المؤكد عليه اجتماعيا، وأي إمكانية
لكونها قد تكون موضوع رغبة أو فاعل في علاقة عاطفية أو جنسية مع رجل غير زوجها، تتم
إدانتها بقوة، والأهم تعمل العائلة، والمجتمع ككل، على الحيلولة دون توفر شروط تلك
الإمكانية، لهذا تكون حرية المرأة المتزوجة مقيدة، وفي المقابل يتم تعويضها عن تلك
القيود بنوع من التبجيل الاجتماعي خاصة في حالة تحولها إلى أم، أي تحولها إلى عنصر
منتج للحياة في المجتمع، إنها تساهم عبر خصوبتها
في حفظ وتجديد وتكثير النسل، وهذا سبب أساسي للتبجيل الذي تحضى به المرأة المتزوجة/الأم،
مع أن الأمومة كحالة مفصولة عن سببها المقبول اجتماعيا الذي هو الزواج تصير منبوذة
بشدة ومدانة في مجتمعنا التقليدي، فالأم العازبة، وإن كانت الدولة عن طريق مجموعة قوانين
توفر لها بعض الحماية، فإن المجتمع لا يقبلها بشكل سوي، لهذا يرتبط تبيجل المرأة كأم
بالزواج، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة التي يتم عبرها قبول الوافدين الجدد على
المجتمع (الأبناء).
إن معظم الأساطير المبنية حول الزواج؛ بصيغة أكثر تحديدا
معظم الحكايات التي يتربى عليها الأطفال ويقرأها الكبار بنهم لكونها تندرج ضمن وسائل
التنشئة الاجتماعية، تقدم الخلاصة المطلوبة والمرضي عنها للعلاقة بين الرجال والنساء
في الصيغة المتداولة: "وعاشوا في ثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات"؛ إن المآل
الطبيعي للعلاقة غير المحارمية بين الرجال والنساء هو الزواج وإنجاب الأطفال، وكل الحكايات،
الأساطير، التوجيهات الدينية والأخلاقية، وبعض القوانين، تحصر العلاقة في الطريق المؤدية
للزواج وتدين، وتعاقب من يجرؤ على سلوك الطرق الأخرى الضالة. إن هذا التصور الذي يمعن
المجتمع في بنائه بشكل متقن وتلقينه لأفراده منذ الصغر يبدو قامعا للرغبة، ومضادا لجوهر
الحب الذي يتأسس غالبا ضدا عن، ولمغالبة التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية التي
تحرم الفرد من عيش عواطفه ورغباته دون تدخل وتوجيه من العائلة وجماعات الانتماء، وهو
أيضا تصور خاصي للحب كخبرة تنمو وتنبني بالتجربة/ التجارب، فحصر مستقبل الحب أو نهايته،
حسب التعبير الحزين والمفارق الذي كرسته السينما المصرية، في الزواج وتكوين عائلة وإنجاب
أطفال، هو أمر فيه الكثير من التعسف، وهو ناتج عن تصور مثالي ومغرق في الأخلاقيات التي
تراعي الانضباط الاجتماعي واحترام القيم الأسرية المؤكد عليها اجتماعيا والتي تعمل
على حراسة الشباب، الشابات بدرجة أكثر، من الزلل الأخلاقي والطيش الجنسي الذي يرافق
العلاقات الحرة أو النزوات حسب التوصيف الأكثر إدانة لعلاقات الحب التي تجد تحققها
بعيدا عن الزواج، ويرى طرفاها أن الزواج ليس هو المآل الحتمي للعلاقة مع أنه قد يكون
مرحلة في سيرورة تلك العلاقة، تؤكد عليها وتعمقها، وبهذا المعنى يكون نتاج ذلك الإجراء،
أي تكوين عائلة، أمرا يعمل على تأكيد الحب وتعميقه، بنفس القدر الذي يعمل إنجاب طفل
على توكيد الحب بين الطرفين ويعبر عن رغبتهما في الارتباط بشكل أعمق من خلال هذا الوافد
الجديد عليهما، وإذا كانت المجتمعات التقليدية لا تزال ترفض، وبشدة، قبول الأطفال القادمين
للعالم، من خارج مؤسسة الزواج، أو بالتعبير الأخلاقي والقانوني الحامل لإدانة كبيرة،
نتيجة علاقة غير شرعية، فإنها في مقابل ذلك تؤكد على الزوج كحاضنة ومفرغة شرعية للرغبات
الجنسية لكل من الرجال والنساء، وهي من خلال ذلك تعمل على حراسة تلك الرغبة، باعتبارها
حاملة للخصب، من الهدر فيما لا ينفع المجتمع، لهذا يتم تبجيل المرأة كلما انتقلت إلى
وضع الأم. وإزاء هذه القيم العائلية والتي تلغي الحب لصالح المؤسسة نجد بأن العلاقات
الحرة يتم نفيها نحو الهامش ونحو الممارسات السرية؛ أي تلك العلاقات التي لا يعني إدانتها
عدم حدوثها وإحجام الأفراد عن إتيانها، فالحب هنا يتحول إلى نوع من الممارسات المناضلة
ضد القولبة المجتمعية ورفضا الانضباط العائلي، إنه، كعلاقة، بمثابة خبرة اجتماعية تقع
على هامش العلاقات المرضي عنها اجتماعيا، وضدا عنها، وأحيانا، في حالة الخيانات الزوجية،
هربا منها ومن ضغطها على الفرد.
يبدو
الحب، كخبرة، واحدا من أكثر الخبرات الفردية انتسابا لمعنى الغواية، إنه سعي مسكون
بالفرح والرهبة نحو ما تجد فيه النفس لذتها والجسد متعته، إنه ممارسة مسكونة بأفكار،
وتصورات، وتجارب سابقة، عن الحب، فالإعجاب بالجميل والافتتان بالجسد المشتهى والسعادة
بالقرب، والرضى بالوصال، كلها خبرات ينميها الفرد عبر التجربة والمعرفة التي تتشكل
لديه بالتكرار وبالانسياق المستمر خلف غواية الحب كحالة تتسم بالتجدد وبإمكانية عيشها
أكثر من مرة بشعور مختلف ومع أشخاص يتعددون وتختلف صفاتهم وطباعهم، فالحب، رغم قوة
النمذجة التي تنتجها الأفلام السينمائية والأغاني وكتب الأدب الرومانسي، عن صفات المحب
والمحبوب، وعن سبل وطرائق التعاطي مع الشخص المرغوب والمحبوب، إلا أن التجربة الفردية
غالبا ما تتجاوز كل تلك الأفكار المسبقة والقيم الجاهزة والتي تعمقها كتب الإرشاد العاطفي
وكتب نماذج الرسائل الغرامية التي تعمق النمطية في القول والفعل لدى المتحابين. يتجاوزها
أولا عن طريق الخيبة التي تمنى بها التطلعات الحالمة التي تتصور بأن الحب والرغبة والجنس؛
هي أمور تحدث بنفس الطريقة، والأسوأ، بنفس الروعة، التي نشاهدها بها عبر الأفلام السينمائية
أو نقرأ عنها من خلال الروايات، وهي خيبة تؤدي بادئ الأمر إلى نوع من النكوص العاطفي؛
أي رغبة في التراجع، ورهبة أمام حدوث الأشياء بشكل غير منتظر، وأقل مما هو محلوم به؛
أي شعور بأن الطريقة خطأ، أو الشريك الذي نبادله الحب ونتشارك معه الجسد ليس أهلا لما
نتطلع إليه معه، إن هذه الخيبة؛ والتي هي نتاج وهم آخر ينضاف إلى مجموع الأوهام العاطفية
التي تجعل من الحب موضوع اكتشاف دائم، والأهم أنه يظل موضوع بناء مستمر، لأنها سرعان
ما تزول حين نسير بالعلاقة من مجال التخيل إلى مجال الواقع، وهذا غالبا ما يحدث عند
التجارب الأولى، خاصة التجربة الجنسية الأولى التي تكون أكثر التجارب الإنسانية مسكونية
بالتصورات والأفكار المسبقة، إنها ما يحدث ونحن مثقلون بالجهل اتجاه ذلك الذي يحدث؛
جهل تعمينا الأفكار المسبقة عن اكتشافه، خاصة الأفكار والتصورات المكتسبة نتيجة احتكاك
سطحي بالثقافة الجنسية عبر الحكايات، الأخبار، الأفلام البورنوغرافية، روايات الإثارة
الجنسية، وعبر الممارسات السطحية التي لا تنزل، إلا عن طريق العين، لما تحت الثياب،
التعمق في التجربة وتجاوز الخيبة الأولى، هو الذي يجعل الحب ينتصر على الأساطير التي
تشكلت في الوعي الفردي، بشكل مسبق، حوله، وهو انتصار للحب على المحبوب أيضا، فكل الأساطير
التي نسجتها تطلعات الحالمين والعشاق المفتونين بلحظة العشق، تؤكد على الحب كحالة انجذاب
قوي نحو شخص بعينه، لا تتشكل العواطف والرغبات إلا معه وباتجاهه، مما يخلق وعيا زائفا
بالحب يرطبه بمحبوب واحد على مستوى الخطابات العاطفية (أغاني، أفلام، روايات، قصائد
غزل ...)، في حين أن المحب لا يتجه في النهاية سوى إلى تصوراته التي يصبغها على محبوب
تصادف أن صفاته تنسجم بنسبة معتبرة مع مجموع التخيلات الخالقة للشغف التي كونها الفرد
عن الحب. إن الحب في وجه من وجوهه ترحال، وليس، كما يدعو ويدعي الكثيرون: إقامة مديدة
في قلب وحضن واحد، بمقدار ما هو بحث عن الحضن الأدفأ والقلب الأكثر "حنية"،
كأن المحب لا يحب من المحبوب سوى خيالاته وشغفه بالأشياء وتصوراته عن العشق والهوى
وصبابات الرغبة، لهذا يبدو المحبوب مجرد ذريعة وسبب لعيش كل ذلك. كأن المحبوب ذات مفصولة
عن الحب، يلبسها المحب ما يشتهي ويرغب ليعيش عبرها ومعها صبابات القلب وملذات الجسد
أياما أو أعواما، لكنه يبقى دائما، وحفاظا على توهج ما بالقلب من مشاعر ورغبات، على
أهبة الاستعداد لترحال جديد محملا بكل ذلك الشغف نحو محبوب آخر له سلطان الجاذبية وسطوة
الافتتان التي تبعد المحب عن محبوبه الذي كان والذي فقد لسبب ما؛ غالبا ما نرجع
السبب لما نسميه بالمشاكل العاطفية أو الخلافات الزوجية، قوة جاذبيته، وبالتالي فقد
القدرة على أن يكون الحامل المثالي لتلك التصورات العاطفية وذلك الشغف الآهل بالهوس
بالأشياء التي يحبها المحب ويشتهي أن يجدها في محبوبه.
ميزة
الحب وغوايته التي لا تنضب أنه دائما قادر على كسر النمطية، لأنه، وعبر الخبرة، يتحول
إلى فكرة تتطور باستمرار عبر التعمق في علاقة الحب الواحدة، أو الانخراط العاطفي في
أكثر من تجربة، وهذا التحول نحو الفكرة يجعل من كل علاقة طقسا لا يختلف كثيرا عن طقوس
العبور المختلفة، حيث كل علاقة تهيء الفرد نحو علاقة أخرى وتكون في ذات الآن مشدودة
نحو العلاقة السابقة عبر جملة من الأفكار والاعتقادات، والأهم عبر جملة من الطقوس العاطفية
والممارسات ذات الطابع المتعوي، كما أنها، وهذا الأهم في الحب، تنمي لدى الفرد/المحب
القدرة على التعامل بشكل أكثر اتزانا مع المحبوب، نتيجة تعمق المعرفة بالطبيعة النفسية
للآخر وبطبيعة التوقعات التي يبنيها كل طرف إزاء الشريك/المحبوب/الآخر.
غواية الجنس: الشبق قبل العاطفة؟ !
هناك
تصور مبتذل، رغم كثرة أنصاره، ورغم كونه حقيقيا في الكثير من الحالات، يقول بأن الحب
ما هو إلا محض إدعاء، وتبرير عاطفي لرغبة صميمة وحقيقية في أعماق طرفي الحب أو أحدها
على الأقل؛ رغبة جنسية محضة يتم تغليفها بادعاءات عاطفية يتواطأ الطرفان على تصديقها
كي لا يشعر أي منهما بأنه مجرد حيوان جنسي أو أداة استفراغ. بعض الفلاسفة من أنصار
مذهب اللذة ينفون وجود العلاقة الجنسية بالمعنى الذي نعطيه لها، ويختصرونها في نرجسية
مفرطة للطرف الراغب في الآخر والذي يحوله إلى، أو بالأحرى يجعل من جسده، مجرد وسيط
لتحقيق لذته وعيش الإشباع الجنسي الذي يبني
على خيالات ذاتية وخبرة سابقة وشعور نفسي اتجاه الرغبة؛ وكل ذلك مفصول في حقيقته ومبتداه
وسيرورته عن شريك الاتصال الجنسي الذي يلبسه الراغب كل خيالاته السابقة وتصوراته وشغفه
بالأشياء؛ إنه في النهاية يتعاطى ما شخص متخيل أكثر مما يتفاعل مع شخص حقيقي، رغم كون
الآخر، المستغل لتحقيق الرغبة الفردية، هو أيضا يقبل على الشريك أو القرين بنفس التصورات
ويجعل منه بدوره مجرد وسيط للانتقال بالرغبة إلى مجال التحقق المتعوي، حيث تظل المتعة
هي الغاية الأبعد والاستجابة الطبيعية لتشكل الرغبات ونموها في نفس وجسد الفرد، تلك
المتعة التي لا يمكن تحقيقها ذاتيا إلا بشكل هش، ومتعب، وغير مرضي للنفس، عبر الاحتلامات
والاستمناء والإقبال على المثيرات التي توفرها المشهدية الجنسية ووسائلها شديدة التطور
والإبهار. رغم كونها في النهاية لا تفعل شيئا أكثر من أنها تعمّق الشعور بالوحدة، وفي
الوقت نفسه تجعل من الخيالات والتصورات المشكلة عن الجنس والمتعة خالية من المعنى،
لأن كل سبل وأدوات تشكيل تلك الخيالات وتنميتها تؤكد على الشريك وتؤكد على العلاقة
باعتبارها تلاحما بين طرفين، وتحقيق المتعة الجنسية ذاتيا عبر الاستمناء وعبر الإقبال
المفرط على المثيرات الجنسية، غالبا ما تكون نتيجته الآنية شعور بالإحباط بمجرد التحقق،
إنها ممارسة تسلم الفرد لشعور حاد بالفراغ وعدم الشعور بالامتلاء والإشباع، رغم أن
نفس الشعور يرافق غالبا العلاقات الجنسية البينية والتي تنتهي بدورها بشعور ما بالفراغ
يتفاوت من شخص إلى آخر، مما يؤدي إلى تجدد الرغبة وبالتالي تجدد الطلب على العلاقة
بشكل مستمر كنوع من تحقيق متعة سمتها الأساسية قابليتها للتكرار بشكل مستمر. بهذا التصور
يعتقد الكثيرون، الفلاسفة وأنصار مذهب الشك، والكتاب المعادون للحب على وجه الدقة،
بأن الحب غير موجود؛ وكل ما يشدّ شخص ما لآخر هو تلك الرغبة الجنسية الملحاحة، شديدة
القوة والسطوة والسلطان، التي تدفع بامرأة ما لحضن رجل ليحتضنهما العري والرغبات التي
تتحقق بالاحتواء والاتحاد بعد أن يتجرد كل واحد منهما من تحفظه وهواجسه مسلما نفسه
لـ، ومتفاعلا بما يملك ويقدر مع الآخر. يرد أنصار الحب والمدافعون عن المشاعر الحقيقة
والعميقة لطرف اتجاه الآخر، على هذا التصور الجنسي للعلاقة بأن رجلا وامرأة لا يكونان
في حالة ممارسة جنسية إلا تأكيدا، واستجابة للحب وعاطفته القوية التي توصلهما لفراش
واحد يختبران عبره تلك المشاعر والرغبات، فالجنس رغبة والحب عاطفة، الرغبة قد تتحقق
بشكل منفصل عن الحب، وغالبا ما يحدث ذلك بالنسبة للكثير من الشركاء، يحدث بشكل واسع
بالنسبة للمتزوجين أيضا والذين يتعايشون جنسيا بشكل طبيعي دون أن يكون بينهما عاطفة
يمكن تسميتها حبا، أيضا العاطفة لا تؤدي بالضرورة إلى نشوء العلاقات الجنسية، خاصة
ذلك النوع من العواطف القريب من الحب في مزاياه وخصائصه كالصداقة التي تنحو لأن تكون
عاطفة ذات أساس ثقافي، أخلاقي بدرجة أقل، بين شخصين يجدان الكثير من القيم التي تجمعهما،
وأيضا يشعران بانجذاب خالي من الرغبة، لكنه قوي، يتعين شعوريا بالحاجة إلى الصديق،
وهو شعور يتعزز باعتقاد الصديق بأن صديقه/ صديقته موضوع ثقة، والأهم من ذلك شخص يمكن
أن تلجأ إليه كملاذ نفسي لاستفراغ الهموم والمشاكل؛ إن الصديق شخص يمكن الاعتماد عليه،
ولهذا فهو شخص قريب عاطفيا، أيضا هو شخص يمكن فهمه نتيجة الخلفية الثقافية التي ساهمت
في تكوين الصداقة بين شخصين، لكن في حالة كون الصداقة بين رجل وامرأة فإنها نادرا ما
تحتوي على رغبات ذات طابع جنسي، أيضا لا تحدث أية علاقة جنسية في إطار علاقة الصداقة،
إلا في حالات معينة ذات طابع خاص. لهذا جين نتحدث عن الحب كعاطفة فنحن نتحدث بالضرورة
عن الجنس كعلاقة ملازمة للحب، أو كهدف ومسعى، وغاية مرتجاة ومشتهاة من الطرفين، ورغم إمكانية عدم حدوثها واقعيا، فإن الرغبة في
حدثوها وتمني ذلك، جعل من الرغبة الجنسية علامة دالة على الحب، ورغبة شديدة اللصوق
به كعاطفة تتجه نحو التجسيد المادي لها عبر الجنس.